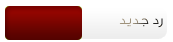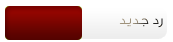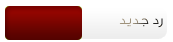تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون (102) واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرّقوا
الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين، والمقصود به وقت نزولها الأوس والخزرج الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر، و «تقاة» مصدر وزنه فعلة، أصله تقية، وقد تقدم قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويصح أن تكون التقاة في هذه الآية جمع فاعل وإن كان لم يتصرف منه فيكون كرماة ورام، أو يكون جمع تقي إذ فعيل وفاعل بمنزلة، والمعنى على هذا: اتقوا الله كما يحق أن يكون متقوه المختصون به، ولذلك أضيفوا إلى ضمير الله تعالى، واختلف العلماء في قوله: حقّ تقاته فقالت فرقة: نزلت الآية على عموم لفظها، وألزمت الأمة أن تتقي الله غاية التقوى حتى لا يقع إخلال في شيء من الأشياء، ثم إن الله نسخ ذلك عن الأمة بقوله تعالى: فاتّقوا اللّه ما استطعتم [التغابن: 16] وبقوله: لا يكلّف اللّه
نفساً إلّا وسعها
[البقرة: 286] قال ذلك قتادة والسدي والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم، وقالت جماعة من أهل العلم: لا نسخ في شيء من هذا، وهذه الآيات متفقات، فمعنى هذه: اتقوا الله حقّ تقاته فيما استطعتم، وذلك أن حقّ تقاته هو بحسب أوامره ونواهيه، وقد جعل تعالى الدين يسرا، وهذا هو القول الصحيح، وألا يعصي ابن آدم جملة لا في صغيرة ولا في كبيرة، وألا يفتر في العبادة أمر متعذر في جبلة البشر، ولو كلف الله هذا لكان تكليف ما لا يطاق، ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية، وإنما عبروا في تفسير هذه الآية بأن قال ابن مسعود رضي الله عنه: حقّ تقاته: هو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وكذلك عبر الربيع بن خيثم وقتادة والحسن، وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
معنى قوله، واتّقوا اللّه حقّ تقاته: جاهدوا في الله حق جهاده ولا نسخ في الآية، وقال طاوس في معنى قوله تعالى: اتّقوا اللّه حقّ تقاته: يقول تعالى، إن لم تتقوه ولم تستطيعوا ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون معناه: دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت وأنتم عليه. هكذا هو وجه الأمر في المعنى، وجاءت العبارة على هذا النظم الرائق الوجيز، ونظيره ما حكى سيبويه من قولهم: لا أرينك هاهنا، وإنما المراد: لا تكن هاهنا فتكون رؤيتي لك، ومسلمون في هذه الآية، هو المعنى الجامع التصديق والأعمال، وهو الدين عند الله وهو الذي بني على خمس). [المحرر الوجيز: 2/304-305]
تفسير قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: واعتصموا بحبل اللّه جميعاً معناه تمنعوا وتحصنوا به، فقد يكون الاعتصام بالتمسك باليد، وبارتقاء القنن، وبغير ذلك مما هو منعة، ومنه الأعصم في الجبل، ومنه عصمة النكاح، و «الحبل» في هذه الآية مستعار لما كان السبب الذي يعتصم به، وصلة ممتدة بين العاصم والمعصوم، ونسبة بينهما، شبه ذلك بالحبل الذي شأنه أن يصل شيئا بشيء، وتسمى العهود والمواثيق حبالا، ومنه قول الأعشى:
وإذا تجوّزها حبال قبيلة = أخذت من الأدنى إليك حبالها
ومنه قول الآخر: [الكامل]
(إني بحبلك واصل حبلي) = ... ... ... ...
ومنه قول الله تعالى: إلّا بحبلٍ من اللّه وحبلٍ من النّاس [آل عمران: 112] واختلفت عبارة المفسرين في المراد في هذه الآية بحبل اللّه، فقال ابن مسعود: «حبل الله» الجماعة، وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال فقيل يا رسول الله: وما هذه الواحدة؟ قال فقبض يده وقال: الجماعة وقرأ، واعتصموا بحبل اللّه جميعاً، وقال ابن مسعود في خطبة: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وقال قتادة رحمه الله: «حبل الله» الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن، وقال السدي: «حبل الله» كتاب الله، وقاله أيضا ابن مسعود والضحاك، وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، وقال أبو العالية: «حبل الله» في هذه الآية هو الإخلاص في التوحيد وقال ابن زيد: «حبل الله» هو الإسلام.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وقيل غير هذا مما هو كله قريب بعضه من بعض، وقوله تعالى: جميعاً حال من الضمير في قوله، اعتصموا، فالمعنى: كونوا في اعتصامكم مجتمعين. ولا تفرّقوا يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله تعالى، وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد، وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، بل ذلك، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلاف أمتي رحمة، وقد اختلف الصحابة في الفروع أشد اختلاف، وهم يد واحدة على كل كافر، وأما الفتنة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمن التفرق المنهي عنه، أما أن التأويل هو الذي أدخل في ذلك أكثر من دخله من الصحابة رضي الله عن جميعهم.
قوله تعالى: ... واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرةٍ من النّار فأنقذكم منها كذلك يبيّن اللّه لكم آياته لعلّكم تهتدون (103)
هذه الآية تدل على أن الخطاب بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرج، وذلك أن العرب وإن كان هذا اللفظ يصلح في جميعها فإنها لم تكن في وقت نزول هذه الآية اجتمعت على الإسلام ولا تألفت قلوبها، وإنما كانت في قصة شاس بن قيس في صدر الهجرة، وحينئذ نزلت هذه الآية، فهي في الأوس والخزرج، كانت بينهم عداوة وحروب، منها يوم بعاث وغيره، وكانت تلك الحروب والعداوة قد دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة، حتى رفعها الله بالإسلام، فجاء النفر الستة من الأنصار إلى مكة حجاجا، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم، وتلا عليهم القرآن، كما كان يصنع مع قبائل العرب، فآمنوا به وأراد الخروج معهم، فقالوا يا رسول الله: إن قدمت بلادنا على ما بيننا من العداوة والحرب، خفنا أن لا يتم ما نريده منك، ولكن نمضي نحن ونشيع أمرك، ونداخل الناس، وموعدنا وإياك العام القابل، فمضوا وفعلوا، وجاءت الأنصار في العام القابل، فكانت العقبة الثانية وكانوا اثني عشر رجلا، فيهم خمسة من الستة الأولين، ثم جاؤوا من العام الثالث، فكانت بيعة العقبة الكبرى، حضرها سبعون وفيهم اثنا عشر نقيبا، ووصف هذه القصة مستوعب في سيرة ابن هشام، ويسر الله تعالى الأنصار للإسلام بوجهين، أحدهما أن بني إسرائيل كانوا مجاورين لهم وكانوا يقولون لمن يتوعدونه من العرب، يبعث لنا نبي الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما رأى النفر من الأنصار محمدا صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي تذكره بنو إسرائيل فلا تسبقن إليه، والوجه الآخر، الحرب التي كانت ضرستهم وأفنت سراتهم، فرجوا أن يجمع الله به كلمتهم كالذي كان، فعدد الله تعالى عليهم نعمته في تأليفهم بعد العداوة، وذكرهم بها، وقوله تعالى: فأصبحتم عبارة عن الاستمرار وإن كانت اللفظة مخصوصة بوقت ما، وإنما خصت هذه اللفظة بهذا المعنى من حيث هي مبدأ النهار، وفيها مبدأ الأعمال، فالحال التي يحسها المرء من نفسه فيها هي حاله التي يستمر عليها يومه في الأغلب، ومنه قول الربيع بن ضبع: [المنسرح]
أصبحت لا أحمل السلاح ولا = أملك رأس البعير إن نفرا
و «الإخوان» جمع أخ، ويجمع إخوة، وهذان أشهر الجمع فيه، على أن سيبويه رحمه الله يرى أن إخوة اسم جمع، وليس ببناء جمع لأن فعلا لا يجمع على فعلة، قال بعض الناس: الأخ في الدين يجمع إخوانا، والأخ في النسب يجمع إخوة: هكذا كثر استعمالهم.
قال القاضي أبو محمد. وفي كتاب الله تعالى: إنّما المؤمنون إخوةٌ الحجرات: 10] وفيه، أو بني إخوانهنّ [النور: 31]، فالصحيح أنهما يقالان في النسب، ويقالان في الدين، و «الشفا» حرف كل جرم له مهوى، كالحفرة والبئر والجرف والسقف والجدار ونحوه، ويضاف في الاستعمال إلى الأعلى، كقوله شفا جرفٍ [التوبة: 109] وإلى الأسفل كقوله شفا حفرةٍ، ويثنى شفوان، فشبه تعالى كفرهم الذي كانوا عليه وحربهم المدنية من الموت بالشفا، لأنهم كانوا يسقطون في جهنم دأبا، فأنقذهم الله بالإسلام، والضمير في منها عائد على النار، أو على «الحفرة»، والعود على الأقرب أحسن، وقال بعض الناس حكاه الطبري: إن الضمير عائد على «الشفا»، وأنث الضمير من حيث كان الشفا مضافا إلى مؤنث، فالآية كقول جرير:
رأت مرّ السنين أخذن منّي = كما أخذ السّرار من الهلال
إلى غير ذلك من الأمثلة.
قال القاضي: وليس الأمر كما ذكر، والآية لا يحتاج فيها إلى هذه الصناعة، إلا لو لم تجد معادا للضمير إلا «الشفا»، وأما ومعنا لفظ مؤنث يعود الضمير عليه، ويعضده المعنى المتكلم فيه، فلا يحتاج إلى تلك الصناعة وقوله تعالى: كذلك يبيّن اللّه لكم آياته إشارة إلى ما بين في هذه الآيات، أي فكذلك يبين لكم غيرها، وقوله، لعلّكم ترجّ في حق البشر، أي من تأمل منكم الحال رجا الاهتداء). [المحرر الوجيز: 2/305-309]
تفسير قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله تعالى: ولتكن منكم أمّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (104) ولا تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذابٌ عظيمٌ (105)
قرأ الحسن والزهري وأبو عبد الرحمن وعيسى بن عمر وأبو حيوة: «ولتكن» بكسر اللام على الأصل، إذ أصلها الكسر، وكذلك قرؤوا لام الأمر في جميع القرآن، قال الضحاك والطبري وغيرهما: أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة، فهم خاصة أصحاب الرسول، وهم خاصة الرواة.
قال القاضي: فعلى هذا القول «من» للتبعيض، وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها ويحفظون قوانينها على الكمال، ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك، إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع، وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالما، وذهب الزجّاج وغير واحد من المفسرين، إلى أن المعنى: ولتكونوا كلكم أمة يدعون، «ومن» لبيان الجنس قال: ومثله من كتاب الله، فاجتنبوا الرّجس من الأوثان [الحج: 30] ومثله من الشعر قول القائل: [البسيط]
أخو رغائب يعطيها ويسألها = يأبى الظّلامة منه النّوفل الزّفر
قال القاضي: وهذه الآية على هذا التأويل إنما هي عندي بمنزلة قولك: ليكن منك رجل صالح، ففيها المعنى الذي يسميه النحويون، التجريد، وانظر أن المعنى الذي هو ابتداء الغاية يدخلها، وكذلك يدخل قوله تعالى: من الأوثان ذاتها ولا تجده يدخل قول الشاعر: منه النوفل الزفر، ولا تجده يدخل في «من» التي هي صريح بيان الجنس، كقولك ثوب من خز، وخاتم من فضة، بل هذه يعارضها معنى التبعيض، ومعنى الآية على هذا التأويل: أمر الأمة بأن يكونوا يدعون جميع العالم إلى الخير، الكفار إلى الإسلام، والعصاة إلى الطاعة، ويكون كل واحد من هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة، قال أهل العلم: وفرض الله بهذه الآية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من فروض الكفاية إذا قام به قائم سقط عن الغير، وللزوم الأمر بالمعروف شروط، منها أن يكون بمعروف لا بتخرق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان آمرا بمعروف، فليكن أمره ذلك بمعروف، ومنها أن لا يخاف الآمر أذى يصيبه، فإن فعل مع ذلك فهو أعظم لأجره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
قال القاضي: والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب، ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة، وحملهم على جادة العلم، وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم، ولهم هي اليد، وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا، وهذا في المنكر الذي له دوام، وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر، كالسلب والزنى ونحوه، فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة، ويحسن لكل مؤمن أن يحتمل في تغيير المنكر، وإن ناله بعض الأذى، ويؤيد هذا المنزع أن في قراءة عثمان بن عفان وابن مسعود وابن الزبير «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويستعينون بالله على ما أصابهم»، فهذا وإن كان لم يثبت في المصحف، ففيه إشارة إلى التعرض لما يصيب عقب الأمر والنهي، كما هي في قوله تعالى: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك [لقمان: 17] وقوله تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم [المائدة: 105] معناه إذا لم يقبل منكم ولم تقدروا على تغيير منكره، وقال بعض العلماء: «المعروف» التوحيد، والمنكر الكفر، والآية نزلت في الجهاد.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ولا محالة أن التوحيد والكفر هما رأس الأمرين، ولكن ما نزل عن قدر التوحيد والكفر، يدخل في الآية ولا بد، والمفلحون الظافرون ببغيتهم، وهذا وعد كريم). [المحرر الوجيز: 2/309-311]