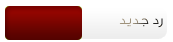تفسير قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبيّنات ثمّ إنّ كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون (32)
جمهور الناس على أن قوله: من أجل ذلك متعلق بقوله كتبنا أي بسبب هذه النازلة ومن جراها كتبنا، وقال قوم: بل هو متعلق بقوله من النّادمين [المائدة: 31] أي ندم من «أجل» ما وقع، والوقف على هذا على ذلك، والناس على أن الوقف من النّادمين، ويقال أجل الأمر أجلا وأجلا إذا جناه وجره، ومنه قول خوات:
وأهل خباء صالح ذات بينهم = قد احتربوا في عاجل أنا آجله
ويقال فعلت ذلك من أجلك بفتح الهمزة ومن إجلك بكسرها، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ذلك بوصل الألف وكسر النون قبلها، وهذا على أن ألقى حركة الهمزة على النون كما قالوا كم إبلك بكسر الميم ووصل الألف. ومن ابراهيم بكسر النون وكتبنا معناه كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك، وخص الله تعالى: بني إسرائيل بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل النفس فيهم محظورا لوجهين، أحدهما فيما روي أن بني إسرائيل أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس في كتاب، وغلظ الأمر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء، والآخر لتلوح مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتهون بل همّوا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، فخصوا بالذكر لحضورهم مخالفين لما كتب عليهم، وقوله تعالى: بغير نفسٍ معناه بغير أن تقتل نفسا فتستحق القتل، وقد حرم الله تعالى نفس المؤمن إلا بإحدى ثلاث خصال، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس ظلما وتعديا. وهنا يندرج المحارب، والفساد في الأرض بجميع الزنا والارتداد والحرابة، وقرأ الحسن «أو فسادا في الأرض» بنصب الفساد على فعل محذوف وتقديره أو أتى فسادا أو أحدث فسادا، وحذف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليه، وقوله تعالى: فكأنّما قتل النّاس جميعاً اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه، فروي عن ابن عباس أنه قال المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنّما أحيا النّاس جميعاً.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا قول لا تعطيه الألفاظ، وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا. ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها مخافتي واستحياها أن يقتلها فهو كمن أحيا الناس جميعا. وقال عبد الله بن عباس أيضا، المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ.
وقال ابن عباس أيضا وغيره المعنى من قتل نفسا فأوبق نفسه فكأنه قتل الناس جميعا إذ يصلى النار بذلك ومن سلم من قتلها فكأنه سلم من «قتل الناس جميعا»، وقال مجاهد الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول لو «قتل الناس جميعا» لم يزد على ذلك. ومن لم يقتل أحدا فقد حيي الناس منه، وقال ابن زيد المعنى أي من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من «قتل الناس جميعا». قال ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له قتله، وقاله الحسن أيضا أي هو العفو بعد القدرة، وقال مجاهد ومن أحياها أنقذها من حرق أو غرق، وقال قوم لما كان المؤمنون كلهم يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس جميعا.
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وهذا قول متداع ولم يتخلص التشبيه إلى طرف في شيء من هذه الأقوال، والذي أقول إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع الجهات، لكن الشبه قد تحصل من ثلاث جهات. إحداها القود فإنه واحد، والثانية الوعيد، فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار، وتلك غاية العذاب، فإن فرضناه يخرج من النار بعد بسبب التوحيد فكذلك قاتل الجميع ان لو اتفق ذلك، والثالثة انتهاك الحرمة، فإن نفسا واحدة، في ذلك وجميع الأنفس سواء، والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع، ومثال ذلك رجلان حلفا على شجرتين ألا يطعما من ثمرهما شيئا، فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته وطعم الآخر ثمر شجرته كله، فقد استويا في الحنث، وقوله تعالى: ومن أحياها فيه تجوز لأنها عبارة عن الترك والإنقاذ وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع إنما هو لله تعالى.
وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمرود، أنا أحيي، سمى الترك إحياء، ومحيي نفس كمحيي الجميع في حفظ الحرمة واستحقاق الحمد، ثم أخبر الله تعالى عن «بني إسرائيل» أنهم جاءتهم الرسل من الله بالبينات في هذا وفي سواه، ثم لم يزل الكثير منهم بعد ذلك في كل عصر يسرفون ويتجاوزون الحدود، وفي هذه الآية إشارة إلى فعل اليهود في همهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى سائر ذلك من أعمالهم). [المحرر الوجيز: 3/150-153]
تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدّنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ (33) إلاّ الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ (34)
اقتضى المعنى في هذه الآية كون إنّما حاصرة الحصر التام، واختلف الناس في سبب هذه الآية، فروي عن ابن عباس والضحاك أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عكرمة والحسن: نزلت الآية في المشركين.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وفي هذا ضعف، لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل حال، وقال أنس بن مالك وجرير بن عبد الله وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهم: إن الآية نزلت في قوم من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في لقاح الصدقة، وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها.
فخرجوا فيها فلما صحوا قتلوا الرعاء واستاقوا الإبل فجاء الصريخ فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر فنودي في الناس يا خيل الله اركبي، فركب رسول الله على أثرهم فأخذوا، وقال جرير بن عبد الله فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى إذا أدركناهم، وقد أشرفوا على بلادهم فجئنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال جميع الرواة فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، ويروى وسمل، وتركهم في جانب الحرة يستسقون فلا يسقون، وفي حديث جرير، فكانوا يقولون الماء ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار، وفي بعض الروايات عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم، قال أبو قلابة، هؤلاء كفروا وقتلوا وأخذوا الأموال وحاربوا الله ورسوله، وحكى الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ووقفت الأمر على هذه الحدود، وقال بعضهم وجعلها الله عتابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على سمل الأعين، وحكي عن جماعة من أهل العلم أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل لأن ذلك وقع في المرتدين.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لا سيما وفي بعض الطرق أنهم سملوا أعين الرعاة قالوا، وهذه الآية هي في المحارب المؤمن، وحكى الطبري عن السدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمل أعين العرنيين وإنما أراد ذلك فنزلت الآية ناهية عن ذلك.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا قول ضعيف تخالفه الروايات المتظاهرة، ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام، واختلفوا فيمن هو الذي يستحق اسم الحرابة، فقال مالك بن أنس رحمه الله، المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو برية فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة، وقال بهذا القول جماعة من أهل العلم، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل العلم، لا يكون المحارب إلا القاطع على الناس في خارج الأمصار، فأما في المصر فلا.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: يريدون أن القاطع في المصر يلزمه حد ما اجترح من قتل أو سرقة أو غصب ونحو ذلك. والحرابة رتب أدناها إخافة الطريق فقط لكنها توجب صفة الحرابة، ثم بعد ذلك أن يأخذ المال مع الإخافة ثم بعد ذلك أن يقتل مع الإخافة ثم بعد ذلك أن يجمع ذلك كله، فقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: في أي رتبة كان المحارب من هذه الرتب فالإمام مخير فيه في أن يعاقبه بما رأى من هذه العقوبات، واستحسن أن يأخذ في الذي لم يقتل بأيسر العقوبات.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لا سيما إن كانت زلة ولم يكن صاحب شرور معروفة، وأما إن قتل فلا بد من قتله، وقال ابن عباس رضي الله عنه والحسن وأبو مجلز وقتادة وغيرهم من العلماء بل لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب، فمن أخاف الطرق فقط فعقوبته النفي، ومن أخذ المال ولم يقتل فعقوبته القطع من خلاف. ومن قتل دون أخذ مال فعقوبته القتل، ومن جمع الكل قتل وصلب، وحجة هذا القول أن الحرابة لا تخرج عن الإيمان ودم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس، فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله، وقد روي عن ابن عباس والحسن أيضا وسعيد بن المسيب وغيرهم مثل قول مالك: إن الإمام مخير، ومن حجة هذا القول أن ما كان في القرآن «أو. أو»، فإنه للتخيير، كقوله تعالى: ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ [البقرة: 196] وكآية كفارة اليمين وآية جزاء الصيد.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ورجح الطبري القول الآخر وهو أحوط للمفتي ولدم المحارب وقول مالك أسد للذريعة وأحفظ للناس والطرق، والمخيف في حكم القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العقوبات استحسانا، وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال سأل رسول الله جبريل عليهما السلام عن الحكم في المحارب، فقال: من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ، ورجله للإخافة ومن قتل فاقتله، ومن جمع ذلك فاصلبه.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبقي النفي للمخيف فقط، وقوله تعالى: يحاربون اللّه تغليظ جعل ارتكاب نهيه محاربة، وقيل التقدير يحاربون عباد الله، ففي الكلام حذف مضاف، وقوله تعالى: ويسعون في الأرض فساداً تبيين للحرابة أي: ويسعون بحرابتهم، ويحتمل أن يكون المعنى ويسعون فسادا منضافا إلى الحرابة، والرابط إلى هذه الحدود إنما هو الحرابة، وقرأ الجمهور «يقتّلوا، يصلّبوا، تقطّع» بالتثقيل في هذه الأفعال للمبالغة والتكثير، والتكثير هنا إنما هو من جهة عدد الذين يوقع بهم كالتذبيح في بني إسرائيل في قراءة من ثقل يذبّحون وقرأ الحسن ومجاهد وابن محيصن «يقتلوا، ويصلبوا، تقطع» بالتخفيف في الأفعال الثلاثة، وأما قتل المحارب فبالسيف ضربة العنق، وأما صلبه فجمهور من العلماء على أنه يقتل ثم يصلب نكالا لغيره، وهذا قول الشافعي، وجمهور من العلماء على أنه يصلب حيا ويقتل بالطعن على الخشبة، وروي هذا عن مالك وهو الأظهر من الآية وهو الأنكى في النكال، وأما القطع فاليد اليمنى من الرسغ والرجل الشمال من المفصل، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقطع اليد من الأصابع ويبقي الكف والرجل من نصف القدم ويبقي العقب واختلف العلماء في النفي فقال السدي: هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حدّ الله ويخرج من دار الإسلام، وروي عن ابن عباس أنه قال: نفيه أن يطلب وقاله أنس بن مالك، وروي ذلك عن الليث ومالك بن أنس غير أن مالكا قال: لا يضطر مسلم إلى دخول دار الشرك، وقال سعيد بن جبير: النفي من دار الإسلام إلى دار الشرك، وقالت طائفة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز: النفي في المحاربين أن ينفوا من بلد إلى غيره مما هو قاص بعيد، وقال الشافعي: ينفيه من عمله، وقال أبو الزناد: كان النفي قديما إلى دهلك وباضع وهما من أقصى اليمن، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة: النفي في المحاربين السجن فذلك إخراجهم من الأرض.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والظاهر أن الأرض في هذه الآية هي أرض النازلة، وقد جنب الناس قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب ومنه حديث الذي ناء بصدر، نحو الأرض المقدسة، وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب المنفي مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وإفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب ترك مسرحا، وهذا هو صريح مذهب مالك: أن يغرب ويسجن حيث يغرب، وهذا هو الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري وهو الراجح لأن نفيه من أرض النازلة أو الإسلام هو نص الآية وسجنه بعد بحسب الخوف منه، فإذا تاب وفهم حاله سرح وقوله تعالى: ذلك لهم خزيٌ إشارة إلى هذه الحدود التي توقع بهم، وغلظ الله الوعيد في ذنب الحرابة بأن أخبر أن لهم في الآخرة عذابا عظيما مع العقوبة في الدنيا، وهذا خارج عن المعاصي الذي في حديث عبادة بن الصامت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو له كفارة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب، وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا، ويجرى هذا الذنب مجرى غيره، وهذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة، اما أن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وعظم الذنب، والخزي في هذه الآية الفضيحة والذل والمقت). [المحرر الوجيز: 3/153-158]
تفسير قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: إلّا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم استثنى عز وجل التائب قبل أن يقدر عليه وأخبر بسقوط حقوق الله عنه بقوله تعالى: فاعلموا أنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ واختلف الناس في معنى الآية فقال قتادة والزهري في كتاب الاشراف: ذلك لأهل الشرك.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب، وهذا ضعيف، والعلماء على أن الآية في المؤمنين وأن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة ولا نظر للإمام فيه إلا كما ينظر في سائر المسلمين، فإن طلبه أحد بدم نظر فيه وأقاد منه إذا كان الطالب وليا، وكذلك يتبع بما وجد عنده من مال الغير وبقيمة ما استهلك من الأموال، هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ذكره ابن المنذر، وقال قوم من الصحابة والتابعين: إنه لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده بعينه، وأما ما استهلك فلا يطلب به، وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه، وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب بحارثة بن بدر الغداني فإنه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه فكتب له بسقوط الأموال والدم كتابا منشورا، وحكى الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال: لا تقبل توبة المحارب، ولو قبلت لاجترؤوا وكان فساد كثير ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبا لم أر عليه عقوبة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لا أدري هل أراد ارتد أم لا، وقال الأوزاعي نحوه إلا أنه قال: إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام أو بقي عليه ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه قبلت توبته.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والصحيح من هذا كله مذهب الفقهاء الذي قررته آنفا أن حكم الحرابة يسقط ويبقى كسائر المسلمين، واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع فيه السارق، فقال مالك: ذلك كالكثير، وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من المحاربين إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق). [المحرر الوجيز: 3/158-159]