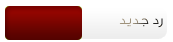● البيان الإلهي للقرآن ●
أول بيان للقرآن هو بيان منزّله جلّ وعلا، وهو تعالى الأعلم بمراده، وقد تكفّل ببيانه ، ويسّره للذكر، وأحكمه وفصلّه، وجعله بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور.
- قال الله تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه}
- وقال تعالى: {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً} أي بيانا وتفصيلا، ومن ذلك بيان الله لما أنزل في القرآن.
- وقال تعالى: {وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين} مفصلا: أي مبينا.
- وقال تعالى: {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين (15) يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيمٍ}
- وقال تعالى: {حم . والكتاب المبين} في مطلع سورتي الزخرف والدخان، وهذا إقسام من الله تعالى بالقرآن بصفة من أظهر صفاته وهو أنه قرآن مبين؛ يبين بعضه بعضاً، ويبين للناس بيانا مفصلا ما يحتاجون إليه ليهتدوا إلى صراط الله المستقيم وينالوا رضوانه وثوابه، ويسلموا من سخطه وعقابه.
وقد ضرب الله تعالى للناس في هذا القرآن من كلّ مثل، وصرّف لهم الآيات، وجعل كتابه نوراً مبيناً، وهادياً للتي هي أقوم، وفرقانا يفرق بين الحقّ والباطل، وعصمة من الضلالة لمن تمسّك به، ودعا إلى اتّباعه فقال : {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155)}، وقال تعالى: {فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى}؛ وهذا يستلزم أن يكون في كلام الله من البيان ما يتيسر به اتباع الهدى ؛ كما هو صريح دلالة قول الله تعالى: {ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر}.
والمقصود من كلّ ما تقدّم أنّ أوّل بيان لمعاني القرآن هو بيان الله جلّ وعلا، وأجلّ البيان بيانه، وأحسن التفسير تفسيره.
● أنواع البيان الإلهي
البيان الإلهي للقرآن على أربعة أنواع:
النوع الأول: تفسير القرآن للقرآن.
وهذا النوع منه ما هو صريح ومنه ما يدخله الاجتهاد ؛ والذي يعدّ من التفسير الإلهي هو ما يدلّ على المعنى صراحة من غير التباس، كما في قول الله تعالى: {والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق . النجم الثاقب}.
ففسّر الله تعالى المراد بالطارق بأنه النجم الثاقب.
وأما التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن فما أصاب فيه المجتهد مراد الله تعالى، فقد وفق فيه لبيان الله للقرآن بالقرآن، وما أخطأ فيه أو أصاب فيه بعض المعنى دون بعض فلا يصح أن ينسب اجتهاده إلى التفسير الإلهي للقرآن.
وتفسير القرآن للقرآن على أنواع كثيرة؛ فمنه تفسير إحدى القراءات لغيرها، وقد قال مجاهد بن جبر رحمه الله: (لو كنت قرأت قراءة ابن مسعودٍ لم أحتج أن أسأل ابن عباسٍ عن كثيرٍ من القرآن مما سألت). رواه الترمذي.
ومنه تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح، ومنه بيان المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام؛ إلى غير ذلك من أنواعه التي تبحث في طرق التفسير.
النوع الثاني: تفسير القرآن بالحديث القدسي.
وهو أن يرد في الأحاديث القدسية ما يبيّن مراد الله جلّ وعلا ببعض ما ورد في كتابه.
ومن أمثلته ما رواه الإمام أحمد والدارمي والترمذي والحاكم وغيرهم من طرق عن سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: {هو أهل التقوى وأهل المغفرة} قال: قال الله عز وجل: (أنا أهل أن أتقى؛ فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له). حسّنه الترمذي، وصححه الحاكم في المستدرك، وضعّفه جماعة من أهل الحديث لتفرّد سهيل القطعي به وهو مضعّف عند أهل الحديث.
النوع الثالث: ما نزل من الوحي على النبيّ صلى الله عليه وسلم لبيان تفسير بعض ما أنزل الله في القرآن، ومن ذلك الأخبار عن المغيّبات وتفصيل ما لا يُدرك إلا بتوقيف من الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم، فهذا منشؤه من الله تعالى، ولكن لأجل أن لفظه مؤدّى من النبي صلى الله عليه وسلم جرى استعمال أهل العلم على اعتباره من التفسير النبوي.
النوع الرابع: البيان القدري لبعض معاني القرآن
ويلحق بالبيان الإلهي ما يجعله الله من الآيات البينات الدالة على مراده؛ فيقدر أموراً يظهر بها المعنى الذي أراده وقد يكون وهم فيه من وهم، وأخطأ فيه من أخطأ.
كما في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي الكبرى من حديث الحسن البصري عن الزبير بن العوام، قال: " لما نزلت هذه الآية {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةً} الآية، قال: ونحن يومئذٍ متوافرون، قال: فجعلت أتعجب من هذه الآية: أي فتنةٍ تصيبنا؟ ما هذه الفتنة؟ حتى رأيناها ".
وفي مسند الإمام أحمد من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه؟
فقال الزبير: (إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعمر، وعثمان: {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةً} لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت).
ويقع مثل هذا النوع في شرح بعض الأحاديث النبوية؛ كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال: «أطولكن يدًا»؛ فأخذوا قصبةً يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدًا، فلما ماتت زينب علمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة).
وفي رواية في المستدرك عن عائشة أنها قالت: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشٍ زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأةً قصيرةً، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة قال: «وكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله عز وجل».
- ومن هذا النوع: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: {غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله}؛ كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرها من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذكره لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أما إنهم سيغلبون )).
قال: فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً؛ فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا؛ فجعل أجلاً خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( ألا جعلتها إلى دون العشر )) قال: قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد.
قال: فذلك قوله: {الم. غلبت الروم} إلى قوله: {ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله} "
- وسيقع من هذا على من كذب بما أنزل الله شيء كثير كما قال الله تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق}، وكما قال تعالى: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله}، لكن إذا أتاهم تأويله – أي حقيقةَ ما يؤول إليه – أتاهم في حال لا ينفعهم فيها الإيمان؛ لأن الغيب قد أصبح شهادة.
- كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله: {وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون}؛ فإذا خرجت الدابة على الناس ورأوها عيانا صدقوا بها وكان هذا تأويل وقوعها؛ حتى رُوي أن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة ولم يكن من أهلها ؛ فتأتيه من خلفه وتقول: الآن تصلي؟ فيلتفت إليها فتَسِمه.
والمقصود أن من أنواع البيان الإلهي لمعاني القرآن ما يقدّره الله جلّ وعلا من الأقدار التي تبيّن مراده، وما يأتي من تأويل كلامه جلّ وعلا،
وهذا النوع من البيان له أمثلة لو تتبعها متتبّعٌ لكان حسناً.
وفي كل نوع من أنواع البيان الإلهي مسائل وتفصيل، وإنما المراد هنا بيان أن أوّل نشأة علم التفسير كانت ببيان الله تعالى للقرآن، وأجلّ ذلك ما تضمنه القرآن من الفصاحة والبيان، وتيسيره للذكر والاعتبار، وتفسير بعضه لبعض.
والقرآن يصدّق بعضه بعضاً، يأتلف ولا يختلف، وما أُجمل منه في موضع بيّن في موضع آخر، أو أحيل إلى بيانه.
وقد أنزل الله تعالى كتابه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراطه المستقيم، وقد أحكم الله آياته وفصّلها وبيّنها ليتدبّرها من تبلغه ويتفكّر فيها، وأمر بتدبّر آياته، فقال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن} ، وقال: {أفلم يدبروا القول} ، وقال: {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته}
وما كان الناس لينتفعوا بتدبّره لولا ما فيه من البيان والهدى، ولا سيما في القضايا الكبار التي تكرر بيانها والتأكيد عليها من توحيده جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث بعد الموت، والحساب والجزاء، والجنة والنار، والتصديق بما أخبر الله به، والتفكّر فيما ضربه من الأمثال.
وقال تعالى: {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون}.
● إفادة البيان الإلهي لليقين في أبواب الدين
وسبب تقرير ما تقدّم من بيان الله تعالى للقرآن بأدلّته وأنواعه وأمثلته وبعض تفصيله والتأكيد على إفادته للهدى واليقين تبصير الطالب بأصول تحصّنه من ضلالات طوائف ممن خالفوا في هذا الباب من الفلاسفة والمتكلمين والباطنية وطوائف من الرافضة والصوفية وغيرهم .
فلهؤلاء شبهات كثيرة في محاولة الطعن في بيان القرآن، ودلالته على اليقين في أبواب الدين، حتى يمكنهم أن يتأوّلوه على ما يريدون من باطلهم؛ حتى إنّ منهم من زعم أن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا يمكن فهم المراد منها إلا بالتحاكم إلى القواطع العقلية؛ حتى اجترؤوا على القول بتقديم العقل على النقل.
قال ابن القيّم رحمه الله في شأن هؤلاء وكان لهم صولة وأتباع: (ومن كيد [الشيطان] بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية، والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشْكاة القرآن، وأحالهم على منطق يونان، وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العريَّة عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان، ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين، كإخراج الشعرة من العجين)ا.ه.
وسبب وقوعهم في هذه الفتنة هو إعراضهم عن اتّباع هدى الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفتهم لما يجب أن يتلّقى به خطابه جلّ وعلا من القبول والتعظيم، والتدبّر والتفكّر، والانقياد والتسليم.
وقد قال الله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
فلمّا أعرضوا عن ابتغاء الهدى في كتاب الله افتتنوا بطلبه من أعداء الله؛ فزادوهم ضلالاً وجهلاً، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وفُتنوا بزخارف الأقوال، وأماني الضلال، حتى أشربوا حبّها في قلوبهم ففسدت تصوّراتهم، وفسدت إراداتهم، فنفروا من البيان الإلهي والبيان النبوي وما فيهما من الشفاء التامّ، والعلم والحكمة والهداية، وظنّوا الهدى فيما استحسنوه من علم الكلام، وطرائق المتفلسفة، وافتراءات معظّميهم، وأهوائهم المضطربة، حتى آل بهم الأمر إلى الشكّ والحيرة والضلال المبين.
ومن تأمّل سِيَر كبارهم وعواقب أمورهم وما أصابهم من الشكّ والحيرة والندامة عرف خطر المنهج الذي ساروا عليه، وبُعْدَه عن سبيل المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان.
وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه استعاذ من علمٍ لا ينفعْ، وهذه الاستعاذة دليل على أنّ فيه شرّا يجب التحرّز منه:
- فعن زيد بن علقمة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا)) رواه مسلم.
- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ )) رواه ابن ماجه.