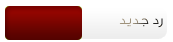تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمًّى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتبٌ أن يكتب كما علّمه اللّه فليكتب ...}
قال ابن عباس رضي الله عنه: «نزلت هذه الآية في السلم خاصة».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «معناه أن سلم أهل المدينة كان بسبب هذه الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا»، وبين تعالى بقوله: {بدينٍ} ما في قوله: {تداينتم} من الاشتراك، إذ قد يقال في كلام العرب: تداينوا بمعنى جازى بعضهم بعضا. ووصفه الأجل بمسمى دليل على أن المجهلة لا تجوز، فكأن الآية رفضتها، وإذا لم تكن تسمية وحد فليس أجل، وذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها فرض بهذه الآية، وذهب الربيع إلى أن ذلك وجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله: {فإن أمن بعضكم بعضاً} [البقرة: 283]. وقال الشعبي: «كانوا يرون أن قوله: {فإن أمن} ناسخ لأمره بالكتب»، وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن زيد، وروي عن أبي سعيد الخدري، وقال جمهور العلماء: «الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب وإن كان غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق»، وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة، وهذا هو القول الصحيح، ولا يترتب نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى الكتب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس، ثم علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال إن وقع ذلك {فليؤدّ} [البقرة: 283] الآية، فهذه وصية للذين عليهم الديون، ولم يجزم تعالى الأمر نصا بأن لا يكتب إذا وقع الائتمان، وأما الطبري رحمه الله فذهب إلى أن الأمر بالكتب فرض واجب وطول في الاحتجاج، وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك.
واختلف الناس في قوله تعالى: {وليكتب بينكم} فقال عطاء وغيره: «واجب على الكاتب أن يكتب»، وقال الشعبي وعطاء أيضا: «إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب»، وقال السدي: «هو واجب مع الفراغ»، وقوله تعالى: {بالعدل} معناه بالحق والمعدلة، والباء متعلقة بقوله تعالى: {وليكتب}، وليست متعلقة ب كاتبٌ لأنه كان يلزم أن لا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبي والعبد والمسخوط إذا أقاموا فقهها، أما أن المنتصبين لكتبها لا يتجوز للولاة ما أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين، وقال مالك رحمه الله: «لا يكتب الوثائق من الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، لقوله تعالى وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل ثم نهى الله تعالى الكتاب عن الإباية، وأبى يأبى شاذ لم يجىء إلا قلى يقلى وأبا يأبى، ولا يجيء فعل يفعل بفتح العين في المضارع إلا إذا رده حرف حلق»، قال الزجّاج: «والقول في أبى أن الألف فيه أشبهت الهمزة فلذلك جاء مضارعه يفعل بفتح العين»، وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك: «أن قوله: {ولا يأب} منسوخ بقوله: {لا يضارّ كاتبٌ ولا شهيدٌ} [البقرة: 282] والكاف في قوله: {كما علّمه اللّه} متعلقة بقوله: {أن يكتب} المعنى كتبا كما علمه الله»، هذا قول بعضهم، ويحتمل أن تكون كما متعلقة بما في قوله: {ولا يأب} من المعنى أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو، وليفضل كما أفضل الله عليه، ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاما عند قوله: {أن يكتب}، ثم يكون قوله: {كما علّمه اللّه} ابتداء كلام، وتكون الكاف متعلقة بقوله: {فليكتب}، أما إذا أمكن الكتاب فليس يجب الكتب على معين، ولا وجوب الندب، بل له الامتناع إلا إن استأجره، وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الحاضر، وأما الكتب في الجملة فندب كقوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] وهو من باب عون الضائع.
قوله عز وجل: {... وليملل الّذي عليه الحقّ وليتّق اللّه ربّه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الّذي عليه الحقّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل ...}
أمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره، وإذا كتبت الوثيقة وأقرّ بها فهو كإملاء له. وأمره الله بالتقوى فيما يملي ونهي عن أن يبخس شيئا من الحق، والبخس النقص بنوع من المخادعة والمدافعة، وهؤلاء الذين أمروا بالإملاء هم المالكون لأنفسهم إذا حضروا، ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمن.
فقال: {فإن كان الّذي عليه الحقّ سفيهاً} وكون الحق يترتب في جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك، والسفيه المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها، مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج، والسفه الخفة، ومنه قول الشاعر وهو ذو الرمة:
مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت ....... أعاليها مرّ الرّياح النّواسم
وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصي، وذلك هو وليه، ثم قال: {أو ضعيفاً} والضعيف هو المدخول في عقله الناقص الفطرة، وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا، الذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليّه وصيه أو أبوه والغائب عن موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر، ووليّه وكيله، وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء، والأولى أنه ممن لا يستطيع، فهذه أصناف تتميز، ونجد من ينفرد بواحد واحد منها، وقد يجتمع منها اثنان في شخص واحد، وربما اجتمعت كلها في شخص، وهذا الترتيب ينتزع من قول مالك وغيره من العلماء الحذاق، وقال بعض الناس: السفيه الصبي الصغير، وهذا خطأ، وقال قوم الضعيف هو الكبير الأحمق، وهذا قول حسن، وجاء الفعل مضاعفا في قوله: {أن يملّ} لأنه لو فك لتوالت حركات كثيرة، والفك في هذا الفعل لغة قريش. و{بالعدل} معناه بالحق وقصد الصواب، وذهب الطبري: «إلى أن الضمير في وليّه عائد على الحقّ»، وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباس، وكيف تشهد على البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين؟ هذا شيء ليس في الشريعة، والقول ضعيف إلا أن يريد قائله أن الذي لا يستطيع أن يملّ بمرضه إذا كان عاجزا عن الإملاء فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذي عجز، فإذا كمل الإملاء أقر به، وهذا معنى لم تعن الآية إليه، ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل بمرض فقط».
قوله عز وجل: {... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ..}
الاستشهاد: طلب الشهادة وعبر ببناء مبالغة في شهيدين دلالة على من قد شهد وتكرر ذلك منه،
فكأنها إشارة إلى العدالة: وقوله تعالى: {من رجالكم} نص في رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم. واختلف العلماء فيهم فقال شريح وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل: «شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وغلبوا لفظ الآية». وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء: «لا تجوز شهادة العبد، وغلبوا نقص الرق، واسم كان الضمير الذي في قوله يكونا».
والمعنى في قول الجمهور، فإن لم يكن المستشهد رجلين أي إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما، وقال قوم: بل المعنى فإن لم يوجد رجلان، ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال، وهذا قول ضعيف، ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور، وقوله: {فرجلٌ وامرأتان} مرتفع بأحد ثلاثة أشياء، إما أن تقدر فليستشهد رجل وامرأتان، وإما فليكن رجل وامرأتان ويصح أن تكون تامة وناقصة، ولكن التامة أشبه، لأنه يقل الإضمار، وإما فرجل وامرأتان يشهدون، وعلى كل وجه فالمقدر هو العامل في قوله: {أن تضلّ إحداهما} وروى حميد بن عبد الرحمن عن بعض أهل مكة أنهم قرؤوا «وامرأتان» بهمز الألف ساكنة.
قال ابن جني: «لا نظير لتسكين الهمزة المتحركة على غير قياس وإنما خففوا الهمزة فقربت من الساكن، ثم بالغوا في ذلك فصارت الهمزة ألفا ساكنة كما قال الشاعر:
يقولون جهلا ليس للشّيخ عيّل ....... لعمري لقد أعيلت وأن رقوب
يريد «وأنا»، ثم بعد ذلك يدخلون الهمزة على هذه الألف كما هي. وهي ساكنة وفي هذا نظر، ومنه قراءة ابن كثير «عن ساقيها» وقولهم يا ذو خاتم قال أبو الفتح: فإن قيل شبهت الهمزة بالألف في أنها ساوتها في الجهر والزيادة والبدل والحذف وقرب المخرج وفي الخفاء فقول مخشوب لا صنعة فيه، ولا يكاد يقنع بمثله، وقوله تعالى: {ممّن ترضون من الشّهداء} رفع في موضع الصفة لقوله عز وجل: {فرجلٌ وامرأتان}.
قال أبو علي: «ولا يدخل في هذه الصفة قوله: {شهيدين} اختلاف الإعراب». قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذا حكم لفظي، وأما المعنى فالرضى شرط في الشهيدين كما هو في الرجل والمرأتين». قال ابن بكير وغيره: «قوله: {ممّن ترضون} مخاطبة للحكام».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذا غير نبيل، إنما الخطاب لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكام، وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض»، وفي قوله: {ممّن ترضون} دليل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم. وقرأ حمزة وحده: «إن تضل» بكسر الألف وفتح التاء وكسر الضاد «فتذكر» بفتح الذال ورفع الراء وهي قراءة الأعمش. وقرأها الباقون «أن تضل» بفتح الألف «فتذكر» بنصب الراء. غير أن ابن كثير وأبا عمرو خففا الذال والكاف، وشددها الباقون، وقد تقدم القول فيما هو العامل في قوله: {أن تضلّ}، وأن مفعول من أجله والشهادة لم تقع لأن تضل إحداهما. وإنما وقع إشهاد امرأتين لأن تذكر
إحداهما إن ضلت الأخرى. قال سيبويه: «وهذا كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن يميل هذا الحائط فأدعمه».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث، قدم في هذه الآية ذكر سبب الأمر المقصود أن يخبر به، وفي ذلك سبق النفوس إلى الإعلام بمرادها، وهذا من أنواع أبرع الفصاحة، إذ لو قال رجل لك: أعددت هذه الخشبة أن أدعم بها الحائط، لقال السامع: ولم تدعم حائطا قائما؟ فيجب ذكر السبب فيقال: إذا مال. فجاء في كلامهم تقديم السبب أخصر من هذه المحاورة». وقال أبو عبيد: «معنى تضلّ تنسى».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء. ويبقى المرء بين ذلك حيران ضالا، ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فيها»، فأما قراءة حمزة فجعل أن الجزاء، والفاء في قوله فتذكّر جواب الجزاء، وموضع الشرط وجوابه رفع بكونه صفة للمذكور، وهما المرأتان، وارتفع «تذكر» كما ارتفع قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم اللّه منه} [المائدة: 95] هذا قول سيبويه.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وفي هذا نظر»، وأما نصب قوله «فتذكر» على قراءة الجماعة فعلى العطف على الفعل المنصوب ب أن، وتخفيف الكاف على قراءة أبي عمرو وابن كثير هو بمعنى تثقيله من الذكر، يقال: ذكرت وأذكرته تعديه بالتضعيف أو بالهمز، وروي عن أبي عمرو بن العلاء وسفيان بن عيينة أنهما قالا: «معنى قوله: «فتذكر» بتخفيف الكاف أي تردها ذكرا في الشهادة، لأن شهادة امرأة تصف شهادة، فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذكر»، وهذا تأويل بعيد، غير فصيح، ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذكر، وذكرت بشد الكاف يتعدى إلى مفعولين، وأحدهما في الآية محذوف، تقديره فتذكر إحداهما الأخرى «الشهادة»، التي ضلت عنها، وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر: «أن تضل» بضم التاء وفتح الضاد بمعنى تنسى، هكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني، وحكى النقاش عن الجحدري ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل الشهادة، تقول: أضللت الفرس والبعير إذا تلفا لك وذهبا فلم تجدهما، وقرأ حميد بن عبد الرحمن ومجاهد «فتذكر» بتخفيف الكاف المكسورة ورفع الراء، وتضمنت هذه الآية جواز شهادة امرأتين بشرط اقترانهما برجل، واختلف قول مالك في شهادتهما، فروى عنه ابن وهب أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدين، أو فيما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك، وروى عنه ابن القاسم أنها تجوز في الأموال والوكالات على الأموال وكل ما جر إلى مال، وخالف في ذلك أشهب وغيره، وكذلك إذا شهدن على ما يؤدي إلى غير مال، ففيها قولان في المذهب.
قوله عز وجل: {... ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند اللّه وأقوم للشّهادة وأدنى ألّا ترتابوا}
قال قتادة والربيع وغيرهما: «معنى الآية إذا دعوا أن يشهدوا فيتقيد حق بشهادتهم، وفي هذا المعنى نزلت، لأنه كان يطوف الرجل في القوم الكثير يطلب من يشهد له فيتحرجون هم عن الشهادة فلا يقوم معه أحد، فنزلت الآية في ذلك»، وقال الحسن بن أبي الحسن: «الآية جمعت أمرين: لا تأب إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة، ولا إذا دعيت إلى أدائها»، وقاله ابن عباس، وقال مجاهد: «معنى الآية، لا تأب إذا دعيت إلى أداء شهادة قد حصلت عندك»، وأسند النقاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية بهذا، قال مجاهد: «فأما إذا دعيت لتشهد أولا، فإن شئت فاذهب، وإن شئت فلا تذهب»، وقاله لا حق بن حميد وعطاء وإبراهيم وابن جبير والسدي وابن زيد وغيرهم.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود وإلا من تعطل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي الندب وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لا سيما إن كانت محصلة، وكان الدعاء إلى أدائها، فإن هذا الظرف آكد لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء»، ولا تسئموا معناه تملوا، وصغيراً أو كبيراً حالان من الضمير في تكتبوه، وقدم الصغير اهتماما به، وهذا النبي الذي جاء عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم، فخيف عليهم أن يملوا الكتب وأقسط معناه أعدل. وهذا أفعل من الرباعي وفيه شذوذ، فانظر هل هي من قسط بضم السين؟ كما تقول: «أكرم» من «كرم» يقال: أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار، ومنه قوله تعالى: {أمّا القاسطون فكانوا لجهنّم حطباً} [الجن: 15] ومن قدر قوله تعالى: {وأقوم للشّهادة} بمعنى وأشد إقامة فذلك أيضا أفعل من الرباعي، ومن قدرها من قام بمعنى اعتدل زال عن الشذوذ، وأدنى معناه أقرب، وترتابوا معناه، تشكوا وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي. «يسأموا» و «يكتبوا» و «يرتابوا» كلها بالياء على الحكاية عن الغائب.
قوله عز وجل: {... إلاّ أن تكون تجارةً حاضرةً تديرونها بينكم فليس عليكم جناحٌ ألاّ تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضارّ كاتبٌ ولا شهيدٌ وإن تفعلوا فإنّه فسوقٌ بكم واتّقوا اللّه ويعلّمكم اللّه واللّه بكلّ شيءٍ عليمٌ (282)}
لما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد، وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها. وقال السدي والضحاك: «هذا فيما كان يدا بيد تأخذ وتعطي، وأن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع»، وقوله تعالى: {تديرونها بينكم} يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض، ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا تقوى البينونة به ولا يعاب عليه حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك بمبايعة الدين وقرأ عاصم وحده «تجارة» نصبا، وقرأ الباقون «تجارة» رفعا، قال أبو علي وأشك في ابن عامر، وإذا أتت بمعنى حدث ووقع غنيت
عن خبر، وإذا خلع منها معنى الحدوث لزمها الخبر المنصوب، فحجة من رفع تجارة إن كان بمعنى حدث ووقع، وأما من نصب فعلى خبر كان، والاسم مقدر تقديره عند أبي علي إما المبايعة التي دلت الآيات المتقدمة عليها، وإما إلّا أن تكون التجارة تجارةً، ويكون ذلك مثل قول الشاعر:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ....... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا
أي إذا كان اليوم يوما.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «هكذا أنشد أبو علي البيت، وكذلك أبو العباس المبرد، وأنشده الطبري:
ولله قومي أيّ قوم لحرّة ....... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا
وأنشده سيبويه بالرفع إذا كان يوم ذو كواكب.
وقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال الطبري: «معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره»، واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو على الندب؟ فقال الحسن والشعبي وغيرهما: «ذلك على الندب»، وقال ابن عمرو والضحاك: «ذلك على الوجوب»، وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرها، وقاله عطاء ورجح ذلك الطبري.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا».
وحكى المهدوي: «عن قوم أنهم قالوا: {وأشهدوا إذا تبايعتم} منسوخ بقوله: {فإن أمن} [البقرة: 283]»، وذكره مكي عن أبي سعيد الخدري.
واختلف الناس في معنى قوله تعالى: {ولا يضارّ كاتبٌ ولا شهيدٌ}، فقال الحسن وقتادة وطاوس وابن زيد وغيرهم: «المعنى ولا يضار الكاتب بأن يكتب ما لم يمل عليه ولا يضار الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منها»، وقال مثله ابن عباس ومجاهد وعطاء إلا أنهم قالوا: «لا يضار الكاتب والشاهد بأن يمتنعا».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «ولفظ الضرر يعم هذا والقول الأول»، والأصل في يضار على هذين القولين «يضارر» بكسر الراء ثم وقع الإدغام وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة، وقال ابن عباس أيضا ومجاهد والضحاك والسدي وطاوس وغيرهم: «معنى الآية ولا يضارّ كاتبٌ ولا شهيدٌ بأن يؤذيه طالب الكتبة أو الشهادة فيقول اكتب لي أو اشهد لي في وقت عذر أو شغل للكاتب أو الشاهد فإذا اعتذرا بعذرهما حرج وآذاهما، وقال خالفت أمر الله ونحو هذا من القول»، ولفظ المضارة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني كلها، والكاتب والشهيد على القول الأول رفع بفعلهما وفي القول الثاني رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله، وأصل يضارّ على القول الثاني «يضارر» بفتح الراء، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يقرؤون «ولا يضارر» بالفك وفتح الراء الأولى، وهذا على معنى أن يبدأهما بالضرر طالب الكتبة والشهادة، وذكر ذلك الطبري عنهم في ترجمة هذا القول وفسر القراءة بهذا المعنى فدل ذلك على أن الراء الأولى مفتوحة كما ذكرنا، وحكى أبو عمرو الداني عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق ومجاهد أن الراء الأولى مكسورة، وحكى عنهم أيضا فتحها، وفك الفعل هي لغة أهل الحجاز والإدغام لغة تميم، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وعمرو بن عبيد «ولا يضار» بجزم الراء، قال أبو الفتح: تسكين الراء مع التشديد فيه نظر، ولكن طريقه أجرى الوصل مجرى الوقف، وقرأ عكرمة «ولا يضارر» بكسر الراء الأولى «كاتبا ولا شهيدا» بالنصب أي لا يبدأهما صاحب الحق بضرر، ووجوه المضارة لا تنحصر، وروى مقسم عن عكرمة أنه قرأ «ولا يضار» بالإدغام وكسر الراء للالتقاء، وقرأ ابن محيصن «ولا يضار» برفع الراء مشددة، قال ابن مجاهد: ولا أدري ما هذه القراءة؟
قال أبو الفتح هذا الذي أنكره ابن مجاهد معروف، وذلك على أن تجعل لا نفيا أي ليس ينبغي أن يضار كما قال الشاعر:
على الحكم المأتيّ يوما إذا انقضى ....... قضيّته أن لا يجوز ويقصد
فرفع ويقصد على إرادة وينبغي أن يقصد فكذلك يرتفع «ولا يضارّ» على معنى وينبغي أن لا يضار، قال: وإن شئت كان لفظ خبر على معنى النهي.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذا قريب من النظر الأول».
وقوله تعالى: {وإن تفعلوا فإنّه فسوقٌ بكم} من جعل المضارة المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما أو نقصهما منه فالفسوق على عرفه في الشرع وهو مواقعة الكبائر، لأن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبشار، وفيه إبطال الحق، ومن جعل المضارة المنهي عنها أذى الكاتب والشاهد بأن يقال لهما: أجيبا ولا تخالفا أمر الله أو جعلها امتناعهما إذا دعيا فالفسوق على أصله في اللغة الذي هو الخروج من شيء كما يقال فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها، وفسقت الرطبة فكأن فاعل هذا فسق عن الصواب والحق في هذه النازلة، ومن حيث خالف أمر الله في هذه الآية فيقرب الأمر من الفسوق العرفي في الشرع، وقوله بكم تقديره فسوق حال بكم، وباقي الآية موعظة وتعديد نعمه والله المستعان والمفضل لا رب غيره، وقيل إن معنى الآية الوعد بأن من اتقى علم الخير وألهمه). [المحرر الوجيز: 2/ 110-124]