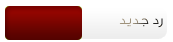(فصل) "لو" و"لولا" و"لوما"
قال جمال الدين محمد بن علي الموزعي المعروف بابن نور الدين (ت: 825هـ): ((فصل) "لو" و"لولا" و"لوما"أما "لو": فإنها حرف لما سيقع لوقوع غيره كما قال سيبويه، كقولك: "لو" جئتني أكرمتك.
وهي أداة شرط تفيد التعليق في الماضي وتختص به، كذا سماها الزمخشري وغيره حرف شرط، وقال بعض الفضلاء: إنما سميت حرف شرط مجازًا لشبهها بالشرط من جهة أن فيها ربط جملة بجملة كما في الشرط من جهة أن معنى الشرط: ربط توقع أمر مستقبل بأمر متوقع مستقبل، والواقع لا يتوقع ولا يتوقف دخوله في الوجود على دخول أمر آخر؛ لأنه قد دخل في الوجود، وقد اتفقوا على إفادتها الربط والتعليق في الماضي، واختلفوا في إفادتها الامتناع على ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو قول الأكثرين أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعًا بطريق الاستلزام كما يمتنع المسبب لامتناع السبب، والمعلول لامتناع العلة.
قال ابن هشام: وهذا باطل بمواضع كثيرة منها قوله تعالى: {ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيءٍ قبلًا ما كانوا ليؤمنوا}.
وقوله تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحرٍ ما نفدت كلمات الله}، وقول عمر رضي الله تعالى عنه: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» وبيانه: أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه، فإذا امتنع «"ما" قام» ثبت «قام» وبالعكس، وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الآية الأولى: ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة، وتكليم الموتى، وحشر عليهم كل شيء قبلًا، وفي الثانية نفاد الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وكون السبعة الأبحر مملؤة مدادًا، وهي تمد ذلك البحر، ويلزم في الأثر: ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف وكل ذلك عكس المراد. انتهى.
وما ذكره من الإبطال باطل فإنه لا يلزم ما ذكره من ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة، ولا يلزم نفاد الكلمات عن نفاد الأبحر، ولا يلزم ثبوت المعصية عند ثبوت الخوف فإن هذا هو مفهوم الموافقة الذي هو بطريق الأولى، لأنه إذا لم يؤمنوا مع نزول الملائكة، وإذا لم تنفد الكلمات مع نفاد الأبحر، وإذا لم يعص مع عدم الخوف، فعدم الإيمان مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى، وعدم نفاد الكلمات مع عدم نفاد الأبحر لعجز الخلق، وعدم المعصية مع ثبوت الخوف أولى.
وقد اتفق على ذلك أهل العلم والنظر من الأصوليين وغيرهم حتى اختلفوا في هذا المفهوم هل فهم بطريق اللغة أو بطريق القياس؟ ويعزى الأخير إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه.
وإنما يلزم ما ذكره لو كان من مفهوم المخالفة، ولو كان كما ذكر لوجب أن يقال في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما} أنه يفهم منه إباحة ضربهما ولا قائل بذلك لأنه مطبوع في غرائز العقلاء: أن من نهث عن تأفيفه فعن ضربه أولى، وأن من لم يعص مع عدم الخوف فعند وجود الخوف أولى، ومن لم يؤمن مع نزول الملائكة وتكليم الموتى فعند عدم ذلك أولى.
القول الثاني: أنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة على امتناع الجواب ولا على ثبوته، وإنما يمتنع الجواب مع الشرط من جهة انتفاء المسبب لانتفاء سببه ونسبه ابن هشام إلى المحققين.
القول الثالث: أنها لا تفيد أكثر من الربط بين الشرط والجواب، والتعليق بالماضي كما دلت "إن" على التعليق في المستقبل ولم تدل على امتناع ولا ثبوت اتفاقًا، وهذا قول الشلوبين.
إذا تقرر هذا فقد ظهر لي بحث نفيس وهو أن لـ "لو" حقيقتين، حقيقة وضعية وحقيقة عرفية، فالحقيقة الوضعية هي: الربط بين السبب والمسبب في الماضي فقط، ولا تدل على امتناع من طريق اللفظ، ولو كانت دلالتها لفظية لما حسن الاستدراك بعدها في قولك: "لو" جاءني زيد لأكرمته لكنه لم يجيء، ولا يمتنع في الكلام: "لو" جاء زيد لأكرمته وقد جاء فأكرمته، ولكني لم أعلم وقوع مثله في كلامهم.
وأما الحقيقة العرفية فهي: الدلالة على الامتناع، وذلك أن العرب استعملوه في التعليق كالامتناع استعمالًا غالبًا حتى هجروا الجانب المحتمل لخلاف الامتناع، ولهذا كثر الاستدراك بعدها في لسانهم، قال الله تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفسٍ هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم}، وقوله تعالى: {ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم}، {ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض}، وقال امرؤ القيس:
ولو أنما أسعى لأدنى معيشةٍ ..... كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال
ولكنما أسعى لمجدٍ مؤثلٍ ..... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
لأن الامتناع أخو النفي، وعبارة سيبويه، شاملة للحقيقتين الوضعية والعرفية.
وفي ظني أن الشلوبين نظر إلى الحقيقة الوضعية وأن ذلك مراده، وأما إفادتها الامتناع فمن العرف، ولا نظن به أنه يمنع فهم الامتناع بوجه من الوجوه فإن ذلك جحد للضرورات، ولم أقف على مقالته إلا بواسطة الناقلين كما قدمت.
ومن قال بالدلالة غلب الحقيقة العرفية ولم يلتفت إلى أصل الوضع، لكنه مهجور في لسانهم ثم افترق هؤلاء على مذهبين كما مضى، فقائل بالامتناع في الشرط والجواب معًا، وقائل بالامتناع في الشرط فقط.
وعندي أن حقيقة قولهما راجعة إلى أنها هل تدل على امتناع الجواب مطابقة أو التزامًا؟ فالأكثرون قائلون بالأول، والمحققون بالثاني.
واعلم أن "لو" إن جاءت رابطة بين ثبوتين صارا نفيين، أو بين نفيين صارا ثبوتين، أو على ثبوت ونفي، فالثابت نفي، والنفي ثبوت والعكس بالعكس.
فمثال الثبوتين: "لو" جاءني زيد أكرمته، فتدل على نفي المجيء والإكرام.
ومثال النفيين: "لو" لم يأتني زيد "لم" أكرمه، فتدل على ثبوت المجيء والإكرام.
ومثال الإثبات والنفي: "لو" جاءني زيد "لم" أعتبه، فتدل على نفي المجيء وحصول العتب.
ومثال النفي والإثبات: "لو" "لم" يأتني عتبته، فتدل على ثبوت المجيء ونفي العتب.
إذا تقررت هذه القاعدة فقد أشكل عليها عند كثير من الفضلاء الأثر المشهور: نعم العبد صهيب "لو" "لم" يخف الله "لم" يعصه؛ لأن "لو" دخلت على نفيين، فيجب حينئذٍ أن يكونا ثبوتين، وذلك يقتضي أنه خاف وعصى وذلك ذم، والكلام سيق للمدح وإبعاد طوره عن المعصية وتكلموا عليه نحو آيات ها أنا أذكرها وأبين ما عندي إن شاء الله تعالى.
قال ابن عصفور: "لو" ها هنا بمعنى "إن" و"إن" إذا دخلت على نفيين لا يكونان ثبوتين فلا يلزم المحذور المتقدم.
وقال الخسرو شاهي: أصل "لو": إنما هو للربط فقط، وانقلاب النفي للثبوت والثبوت للنفي إنما جاء من العرف والحديث جاء بقاعدة اللغة دون العرف.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه وعليهم: إن المسبب الواحد إذا كان له سبب واحد، لزم انتفاؤه عند انتفاء سببه وإذا كان له سببان لا يلزم من انتفاء أحد سببيه انتفاؤه لأنه يثبت مع السبب الآخر.
وغالب الناس طاعتهم لله للخوف فإذا لم يخافوا عصوا ولم يطيعوا، فأخبر أن صهيبًا اجتمع في حقه سببان: الخوف والإجلال لله تعالى: فإذا انتفى الخوف لم تصدر منه المعصية لأجل الإجلال، "فلو" لم يخف الله لم يعصه، وهذا غاية المدحة، كما تقول "لو" لم يمرض فلان لمات، أي: بالهرم، فإنه سبب آخر للموت وحيث يلزم من النفي الثبوت إذا كان للفعل سبب واحد وكلام النحاة محمول عليه.
قلت: وأضعف هذه الأجوبة قول ابن عصفور؛ لأن الكلام سيق لمدحه بما هو عليه من الحال الماضية والحاضرة، وأما ما يستقبل من الزمان فلم يمدح بها فلم يعلم منه حقيقة والشرط مختص بالمستقبل.
ثم يليه في الضعف قول الخسرو شاهي وهو تنزيله للكلام الفصيح على وضع مهجور فمثل هذا الأثر قد ورد في الكتاب والسنة كثيرًا كما ستراه إن شاء الله تعالى.
وأجودها قول الشيخ عز الدين بن عبد السلام لكنه علل بالقياس من جهة الأمر المدلول عليه، وهو أيضًا غير عام لقوله تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرةٍ أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحرٍ ما نفدت كلمات الله}، فإن نفاد كلمات الله سبحانه وعدم نفادها غير معلل بالأسباب.
وقال أبو العباس القرافي: "لو" تستعمل أيضًا لقطع الربط فتكون جوابًا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط، فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط، كما "لو" قال القائل: "لو" لم يكن زيد عالمًا لم يكرم.
فتقول أنت: "لو" لم يكن زيد عالمًا لأكرم، أي: لشجاعته، فتقطع ذلك الربط وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام، لأن ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلام إلا على عدم الربط، كذلك الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم، وأن الغالب على الأوهام أن الشجرة كلها إذا صارت أقلامًا والبحر المالح مع غيره يكتب به، يقول الوهم: ما يكتب بهذا شيء إلا نفد، فقطع الله سبحانه هذا الربط وقال: ما نفدت كلمات الله.
قلت: وأجود من هذا أن يقال: إنما تدل "لو" مع النفيين على الثبوتين إذا كان ذلك من باب مفهوم المخالفة وذلك عند التقابل لأن "ما" نفي ثبت نقيضه وأما موافقة فلا يثبت وإنما يوافقه في النفي، وكذا يقول في عكسه، والأثر مفهومه موافق من باب الأولى، لأنه إذا لم يعص الله تعالى مع عدم الخوف فمع الخوف أولى، وهذا المفهوم الموافق يدل على أن ثم سببًا آخر يمنع من المعصية فحمل على ما يليق بالمناسبة بينه وبين ترك المعصية وهو الحياء والإجلال والمحبة، فالإمام ابن عبد السلام أجاب بمدلول المفهوم، والإجابة بالمفهوم أولى من الإجابة بمدلوله، وقد ورد مثل هذا الأثر كثيرًا في القرآن والسنة، فمن ذلك قول الله تعالى: {ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيءٍ قُبلًا ما كانوا ليؤمنوا}، وقوله تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحرٍ ما نفدت كلمات الله}، وقوله تعالى: {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق}، وقوله تعالى: {ولو أسمعهم لتولوا وهو معرضون} فإن التولي عند عدم السماع أولى، وقوله صلى الله عليه وسلم في بنت أم سلمة: "لو" "لم" تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما طول في صلاة الصبح وقيل له: كادت الشمس تطلع: «لو طلعت ما وجدتنا غافلين» وفي هذا الأثر دليل على أن الإشكال الذي أورده لا يختص بالنفيين، بل يقع مثله في الإثبات والنفي.
ولك أن تجيب عن الأثر من جهة المعنى والقياس بما أجاب به ابن هشام وهو: أنه إذا فقدت المناسبة بين الخوف والمعصية وأنه لا يليق أن تكون سببًا للعصيان، و"لو": إنما جاءت للشرط لربط المسببات بأسبابها وعلمنا انتفاء العلية بذلك، لذلك علمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر وهو الحياء والمهابة والإجلال وهذا راجع إلى جواب ابن عبد السلام لكن هذا أحسن في صيغة القياس.
والجواب الذي ذكرته أحسن وأليق لكونه جوابًا بدال لا بالمدلول عليه والله أعلم.
وترد على خمسة أوجه:
أحدها: الامتناعية، وهي ما تقدم.
الثاني: الشرطية، وهي أن تكون حرف شرط للتعليق بالمستقبل كأختها "إن" ذكره الفراء إلا أنها لا تجزم، كقول الشاعر:
لا يُلفك الراجيك إلا مظهرًا ..... خلق الكرام ولو تكون عديمًا
وكقول الآخر:
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ..... علي ودوني جندلٌ وصفائح
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا ..... إليها صدى من جانب القبر صائح
ومنه قوله تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين}، وقوله تعالى: {ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون}.
وأنكر ابن الحاجب وبدر الدين بن مالك كونها لتعليق المستقبل ويقدر أنها امتناعية فإذا وليها المستقبل أولاه بالماضي أو بالحال، فيقولون في البيت: المقصود فرض هذه الأمور واقعة والحكم عليها مع العلم بعدم وقوعها.
ورد ابن هشام قولهما وأطال في الرد، وحاصله: أن تقديرهم غير مستمر كما في قول الشاعر:
قومٌ إذا حاربوا شدوا مآزرهم ..... دون النساء ولو باتت بأطهار
لأن المقصود تحقيق ثبوت الطهر لا امتناعه، ثم خلاصة الأمر: أن الشرط متى كان مستقبلًا محتملًا، وليس المراد فرضه الآن أو فيما مضى فهي بمعنى "إن" ومتى كان ماضيًا أو حالًا أو مستقبلًا ولكن قصد فرضه الآن أو فيما مضى فهي الامتناعية.
الثالث: المصدرية: فتكون حرفًا مصدريًا بمنزلة "أن" إلا أنها لا تنصب، قاله الفراء، وأبو علي، واختاره ابن مالك.
وهذه إذا وليها الماضي بقي على مضيه، أو المضارع تخلص للاستقبال وأكثر وقوعها بعد: ود، ويود نحو: {ودوا لو تدهن فيدهنون}.
وقوله تعالى: {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة}، وقد تقع بدونهما، ومنه قول بنت النضر بن الحارث:
ما كان ضرك لو مننت وربما ..... من الفتى وهو المغيظ المحنق
وقول الأعشى:
وربما فات قومًا جل أمرهم ..... مع التأني وكان الحزم لو عجلوا
وأكثرهم منعها وجعلها شرطية وقالوا: مفعول «يود» وجواب "لو" محذوفان والتقدير: يود أحدهم التعمير "لو" يعر ألف سنة لسره ذلك.
ويشهد للمثبتين قراءة بعضهم: {ودوا لو تدهن فيدهنوا} بحذف "النون" عطفًا على تدهن الذي معناه: "أن" تدهن.
الرابع: يكون معناها التمني، نحو: "لو" تأتيني فتحدثني بالرفع والنصب، قال الله تعالى: {ودوا لو تدهن فيدهنون} ففي بعض المصاحف {فيدهنوا} قيل: ومنه قوله تعالى: {فلو أن لنا كرة فنكون}، أي: فليت لنا كرة، ولهذا نصب «فنكون» في جوابها كما نصب في جواب "ليت".
واختلف في حقيقتها فقيل: هي "لو" الشرطية أشربت معنى التمني، وقال ابن مالك: هي المصدرية، فهمه عنه ابن هشام.
وقال قوم: هي قسم برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط، ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب "ليت".
الخامس: التقليل، ذكره ابن هشام اللخمي وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتمًا من حديد»، وقيل: ومنه قوله تعالى: {ولو على أنفسكم}).[مصابيح المغاني: 404 - 418]