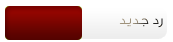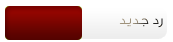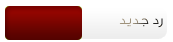تفسير قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: فبما رحمةٍ من اللّه، معناه: فبرحمة من الله «وما» قد جرد عنها معنى النفي ودخلت للتأكيد وليست بزائدة على الإطلاق لا معنى لها، وأطلق عليها سيبويه اسم الزيادة من حيث زال عملها، وهذه بمنزلة قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم [النساء: 155] قال الزجاج: الباء بإجماع من النحويين صلة وفيها معنى التأكيد، ومعنى الآية: التقريع لجميع من أخل يوم- أحد- بمركزه، أي كانوا يستحقون الملام منك، وأن لا تلين لهم، ولكن رحم الله جميعكم، أنت يا محمد بأن جعلك الله على خلق عظيم، وبعثك لتتمم محاسن الأخلاق، وهم بأن لينك لهم وجعلت بهذه الصفات لما علم تعالى في ذلك من صلاحهم وأنك لو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك، وتفرقوا عنك، والفظ: الجافي في منطقه ومقاطعه، وفي صفة النبي عليه السلام في الكتب المنزلة: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، وقال الجواري لعمر بن الخطاب: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله الحديث، وفظاظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كانت مستعملة منه آلة لعضد الحق والشدة في الدين، والفظاظة: الجفوة في المعاشرة قولا وفعلا ومنه قول الشاعر: [البسيط]
أخشى فظاظة عمّ أو جفاء أخ = وكنت أخشى عليها من أذى الكلم
وغلظ القلب: عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة ومن ذلك قول الشاعر: [البسيط]
يبكى علينا ولا نبكي على أحد = لنحن أغلظ أكبادا من الإبل
والانفضاض: افتراق الجموع ومنه فض الخاتم.
قوله تعالى: ... فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكّل على اللّه إنّ اللّه يحبّ المتوكّلين (159) إن ينصركم اللّه فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الّذي ينصركم من بعده وعلى اللّه فليتوكّل المؤمنون (160)
أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة وحق، فإذا صاروا في هذه الدرجة، أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة، فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلا للاستشارة في الأمور والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم [الشورى: 38] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وقال عليه السلام: المستشار مؤتمن، وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل، فقد قال الحسن بن أبي الحسن: ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله، وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير، والشورى بركة، وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافة- وهي أعظم النوازل- شورى، وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، وقد قال في غزوة بدر: أشيروا عليّ أيها الناس، في اليوم الذي تكلم فيه المقداد، ثم سعد بن عبادة، ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل، وأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع. ما فرّطنا في الكتاب من شيءٍ [الأنعام: 38] وكأن الآية نزلت مؤنسة للمؤمنين، إذ كان تغلبهم على الرأي في قصة- أحد- يقتضي أن يعاقبوا بأن لا يشاوروا في المستأنف، وقرأ ابن عباس «وشاورهم في بعض الأمر» وقراءة الجمهور إنما هي باسم الجنس الذي يقع للبعض وللكل، ولا محالة أن اللفظ خاص بما ليس من تحليل وتحريم، والشورى مبينة على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخير، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه، عزم عليه وأنفذه متوكلا على الله، إذ هي غاية الاجتهاد المطلوب منه، وبهذا أمر تعالى نبيه في هذه الآية، وقرأ جابر بن زيد وأبو نهيك وجعفر بن محمد وعكرمة «عزمت» - بضم التاء سمى الله تعالى إرشاده وتسديده عزما منه، وهذا في المعنى نحو قوله تعالى: لتحكم بين النّاس بما أراك اللّه [النساء: 105] ونحو قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكنّ اللّه رمى [الأنفال: 17] فجعل تعالى هزمه المشركين بحنين وتشويه وجوههم رميا، إذ كان ذلك متصلا برمي محمد عليه السلام بالحصباء. وقد قالت أم سلمة ثم عزم الله لي، والتوكل على الله تعالى من فروض الإيمان وفصوله، ولكنه مقترن بالجد في الطاعة والتشمير والحزامة بغاية الجهد: وليس الإلقاء باليد وما أشبهه بتوكل، وإنما هو كما قال عليه السلام: قيدها وتوكل). [المحرر الوجيز: 2/403-406]
تفسير قوله تعالى: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (ثم ثبت تعالى المؤمنين بقوله: إن ينصركم اللّه فلا غالب لكم أي فالزموا الأمور التي أمركم بها ووعدكم النصر معها، و «الخذل»: هو الترك في مواطن الاحتياج إلى التارك، وأصله من خذل الظباء، وبهذا قيل لها: خاذل إذ تركتها أمها، وهذا على النسب أي ذات خذل لأن المتروكة هي الخاذل بمعنى مخذولة، وقوله تعالى: فمن ذا الّذي ينصركم تقدير جوابه: لا من- والضمير في بعده يحتمل العودة على المكتوبة، ويحتمل العودة على الخذل الذي تضمنه قوله إن يخذلكم). [المحرر الوجيز: 2/406]
تفسير قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله تعالى: وما كان لنبيٍّ أن يغلّ ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ثمّ توفّى كلّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون (161) أفمن اتّبع رضوان اللّه كمن باء بسخطٍ من اللّه ومأواه جهنّم وبئس المصير (162) هم درجاتٌ عند اللّه واللّه بصيرٌ بما يعملون (163)
تقدم القول في صيغة: وما كان لكذا أن يكون كذا، في قوله تعالى: وما كان لنفسٍ أن تموت [آل عمران: 145] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «يغل» بفتح الياء وضم الغين، وبها قرأ ابن عباس وجماعة من العلماء، وقرأ باقي السبعة «أن يغل» بضم الياء وفتح الغين، وبها قرأ ابن مسعود وجماعة من العلماء، واللفظة: بمعنى الخيانة في خفاء، قال بعض اللغويين هي مأخوذة من الغلل وهو الماء الجاري في أصول الشجر والدوح، قال أبو عمرو: تقول العرب: أغل الرجل يغل إغلالا: إذا خان، ولم يؤد الأمانة، ومنه قول النمر بن تولب: [الطويل]
جزى الله عنّي جمرة ابنة نوفل = جزاء مغلّ بالأمانة كاذب
وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان، قال أبو علي: وتقول من الغل الذي هو الضغن: غل يغل بكسر الغين، ويقولون في الغلول من الغنيمة: غل يغل بضم الغين، والحجة لمن قرأ يغل أن ما جاء من هذا النحو في التنزيل أسند الفعل فيه إلى الفاعل على نحو ما كان لنا أن نشرك باللّه من شيءٍ [يوسف: 38] ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك [يوسف: 76] وما كان لنفسٍ أن تموت [آل عمران: 145] وما كان اللّه ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم [التوبة: 115] وما كان اللّه ليطلعكم على الغيب [آل عمران: 179] ولا يكاد يجيء: ما كان زيد ليضرب، فيسند الفعل فيه إلى المفعول به، وفي هذا الاحتجاج نظر، وروي عن ابن عباس أنه قرأ «يغل» بضم الغين، فقيل له: إن ابن مسعود قرأ «يغل» بفتح الغين، فقال ابن عباس: بلى والله ويقتل، واختلف المفسرون في السبب الذي أوجب أن ينفي الله تعالى عن النبي أن يكون غالا على هذه القراءة- التي هي بفتح الياء وضم الغين، فقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفة حمراء فقدت من المغانم يوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رسول الله أخذها فنزلت الآية.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: قيل: كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أن في ذلك حرجا، وقيل كانت من منافقين، وقد روي أن المفقود إنما كان سيفا، قال النقاش: ويقال: إنما نزلت لأن الرماة قالوا يوم أحد: الغنيمة الغنيمة أيها الناس، إنما نخشى أن يقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا فهو له، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: خشيتم أن نغل؟ ونزلت هذه الآية، وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طلائع في بعض غزواته ثم غنم قبل مجيئهم، فقسم للناس ولم يقسم للطلائع، فأنزل الله تعالى عليه عتابا، وما كان لنبيٍّ أن يغلّ أي يقسم لبعض ويترك بعضا، وروي نحو هذا القول عن ابن عباس، ويتجه على هذا أن تكون الآية إعلاما بعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه للغنائم، وردا على الأعراب الذين صاحوا به: اقسم علينا غنائمنا يا محمد، وازدحموا حتى اضطروه إلى السمرة التي أخذت رداءه، ونحا إليه الزجّاج، وقال ابن إسحاق: الآية إنما نزلت إعلاما بأن النبي عليه السلام لم يكتم شيئا مما أمر بتبليغه.
قال القاضي: وكأن الآية على هذا في قصة- أحد- لما نزل عليه: وشاورهم في الأمر [آل عمران: 159] إلى غير ذلك مما استحسنوه بعد إساءتهم من العفو عنهم ونحوه، وبالجملة فهو تأويل ضعيف، وكان يجب أن يكون «يغل» بضم الياء وكسر الغين، لأنه من الإغلال في الأمانة، وأما قراءة من قرأ «أن يغل» بضم الياء وفتح الغين، فمعناها عند جمهور من أهل العلم: أن ليس لأحد أن يغله: أي يخونه في الغنيمة، فالآية في معنى نهي الناس عن الغلول في المغانم والتوعد عليه، وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعاصي تعظم مع حضرته لتعين توقيره، والولاة هم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حظهم من التوقير، وقال بعض الناس: معنى «أن يغل» أن يوجد غالا، كما تقول: أحمدت الرجل وجدته محمودا، فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يغل» بفتح الياء وضم الغين، وقال أبو علي الفارسي: معنى «يغل» بضم الياء وفتح الغين يقال له: غللت وينسب إلى ذلك، كما تقول أسقيته، إذا قلت: سقاك الله كما قال ذو الرمة: [الطويل]
وأسقيه حتى كاد ممّا أبثّه = تكلّمني أحجاره وملاعبه
وهذا التأويل موقر للنبي عليه السلام، ونحوه في الكلام: أكفرت الرجل إذا نسبته إلى الكفر، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا آكل سمنا حتى يحيا الناس من أول ما يحيون: أي يدخلون في الحيا وقوله تعالى: ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة وعيد لمن يغل من الغنيمة، أو في زكاته، فيجحدها ويمسكها، فالفضيحة يوم القيامة بأن يأتي على رؤوس الأشهاد بالشيء الذي غل في الدنيا، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ألا يخشى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، ثم ذكر ذلك عليه السلام في بقرة لها خوار وجمل له رغاء، وفرس له حمحمة، وروى نحو هذا الحديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، الحديث بطوله، وروى نحوه أبو حميد الساعدي وعمر بن الخطاب وعبد الله بن أنيس، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أدوا الخياط والمخيط، فقام رجل فجاء بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، وقال في مدعم، إن الشملة التي غل من المغانم يوم خيبر لتشتعل عليه نارا.
قال القاضي: وهذه الفضيحة التي يوقع الله بالغالّ، هي نظيرة الفضيحة التي توقع بالغادر، في أن ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه السلام، وجعل الله هذه المعاقبات حسبما يعهده البشر ويفهمونه، ألا ترى إلى قول الحارد: [الكامل]
أسميّ ويحك هل سمعت بغدرة = رفع اللّواء لنا بها في المجمع
وكانت العرب ترفع للغادر لواء، وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته، وقد تقدم القول في نظير، ثمّ توفّى كلّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون [البقرة: 281] ). [المحرر الوجيز: 2/407-411]
تفسير قوله تعالى: {أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: أفمن اتّبع رضوان اللّه الآية، توقيف على تباين المنزلتين وافتراق الحالتين، والرضوان: مصدر، وقرأه عاصم- فيما روي عنه- بضم الراء- وقرأ جميعهم بكسرها، وحكى أبو عمرو الداني عن الأعمش، أنه قرأها- بكسر الراء وضم الضاد، وهذا كله بمعنى واحد مصدر من الرضى، والمعنى، اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله، ففي الكلام حذف مضاف، وباء بسخطٍ- معناه: مضى متحملا له، والسخط: صفة فعل، وقد تتردد متى لحظ فيها معنى الإرادة، وقال الضحاك: إن هذه الآية مشيرة إلى أن من لم يغل واتقى فله الرضوان، وإلى أن من غل وعصى فله السخط، وقال غيره: هي مشيرة إلى أن من استشهد- بأحد- فله الرضوان، وإلى المنافقين الراجعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهم السخط، وباقي الآية بيّن). [المحرر الوجيز: 2/411-412]
تفسير قوله تعالى: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (واختلف المفسرون في قوله تعالى: هم درجاتٌ من المراد بذلك؟ فقال ابن إسحاق وغيره: المراد بذلك الجمعان المذكوران، أهل الرضوان وأصحاب السخط، أي لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجنة، وفي أطباق النار أيضا، وقال مجاهد والسدي ما ظاهره: إن المراد بقوله هم إنما هو لمتبعي الرضوان، أي لهم درجات كريمة عند ربهم، وفي الكلام حذف مضاف تقديره «هم درجات» والدرجات المنازل بعضها أعلى من بعض في المسافة أو في التكرمة، أو العذاب، وقرأ إبراهيم النخعي «هم درجة» بالإفراد، وباقي الآية وعيد ووعد). [المحرر الوجيز: 2/412]