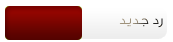تفسير قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (والعامل في إذ فعل، تقديره: واذكر إذ، وابتلى معناه اختبر، وإبراهيم يقال إن تفسيره بالعربية أب رحيم، وقرأ ابن عامر في جميع سورة البقرة «أبراهام»، وقدم على الفاعل للاهتمام، إذ كون الرب مبتليا معلوم، فإنما يهتم السامع بمن ابتلى، وكون ضمير المفعول متصلا بالفاعل موجب تقديم المفعول، فإنما بني الكلام على هذا الاهتمام.
واختلف أهل التأويل في الكلمات، فقال ابن عباس: «هي ثلاثون سهما، هي الإسلام كله لم يتمه أحد كاملا إلا إبراهيم صلوات الله عليه، عشرة منها في براءة {التّائبون العابدون} [التوبة: 112]، وعشرة في الأحزاب {إنّ المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35]، وعشرة في {سأل سائلٌ} [المعارج: 1]» وقال ابن عباس أيضا وقتادة: «الكلمات عشر خصال خمس منها في الرأس المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق الرأس، وقيل بدل فرق الراس: إعفاء اللحية، وخمس في الجسد تقليم الظفر، وحلق العانة، ونتف الإبط، والاستنجاء بالماء، والاختتان» وقال ابن عباس أيضا: «هي عشرة خصال، ست في البدن وأربع في الحج: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، والغسل يوم الجمعة، والطواف بالبيت، والسعي، ورمي الجمار، والإفاضة» وقال الحسن بن أبي الحسن: «هي الخلال الست التي امتحن بها، الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان» وقيل بدل الهجرة: الذبح، وقالت طائفة: هي مناسك الحج خاصة، وروي أن الله عز وجل أوحى إليه أن تطهر، فتمضمض، ثم أن تطهر فاستنشق، ثم أن تطهر فاستاك، ثم أن تطهر فأخذ من شاربه، ثم أن تطهر ففرق شعره، ثم أن تطهر فاستنجى، ثم أن تطهر فحلق عانته، ثم أن تطهر فنتف إبطه، ثم أن تطهر فقلم أظفاره، ثم أن تطهر فأقبل على جسده ينظر ما يصنع فاختتن بعد عشرين ومائة سنة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله وفي البخاري: «أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم».
وقال الراوي: «فأوحى الله إليه إنّي جاعلك للنّاس إماماً يأتمون بك في هذه الخصال، ويقتدي بك الصالحون».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذا أقوى الأقوال في تفسير هذه الآية، وعلى هذه الأقوال كلها فإبراهيم عليه السلام هو الذي أتم».
وقال مجاهد وغيره: «إن الكلمات هي أن الله عز وجل قال لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال إبراهيم: تجعلني للناس إماما، قال الله: نعم، قال إبراهيم: تجعل البيت مثابة، قال الله: نعم، قال إبراهيم وأمنا، قال الله: نعم، قال إبراهيم: وترينا مناسكنا وتتوب علينا، قال الله: نعم، قال إبراهيم: تجعل هذا البلد آمنا، قال الله: نعم، قال إبراهيم: وترزق أهله من الثمرات، قال الله: نعم».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «فعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم»، وقد طول المفسرون في هذا، وذكروا أشياء فيها بعد فاختصرتها، وإنما سميت هذه الخصال كلمات، لأنها اقترنت بها أوامر هي كلمات، وروي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أتم هذه الكلمات أو أتمها الله عليه كتب الله له البراءة من النار، فذلك قوله تعالى: {وإبراهيم الّذي وفّى} [النجم: 37].
والإمام القدوة، ومنه قيل لخيط البناء: إمام، وهو هنا اسم مفرد، وقيل في غير هذا الموضع: هو جمع آم وزنه فاعل أصله آمم، فيجيء مثل قائم وقيام وجائع وجياع ونائم ونيام.
وجعل الله تعالى إبراهيم إماما لأهل طاعته، فلذلك أجمعت الأمم على الدعوى فيه، وأعلم الله تعالى أنه كان حنيفا، وقول إبراهيم عليه السلام: {ومن ذرّيّتي} هو على جهة الدعاء والرغبى إلى الله، أي ومن ذريتي يا رب فاجعل، وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم، أي ومن ذريتي يا رب ماذا يكون؟ والذرية مأخوذة من ذرا يذرو أو من ذرى يذري أو من ذر يذر أو من ذرأ يذرأ، وهي أفعال تتقارب معانيها، وقد طول في تعليلها أبو الفتح وشفى.
وقوله تعالى: {قال لا ينال عهدي} أي قال الله، والعهد فيما قال مجاهد: «الإمامة»، وقال السدي: «النبوءة»، وقال قتادة:«الأمان من عذاب الله»، وقال الربيع والضحاك: «العهد الدين: دين الله تعالى».
وقال ابن عباس: «معنى الآية لا عهد عليك لظالم أن تطيعه، ونصب الظّالمين لأن العهد ينال كما ينال»، وقرأ قتادة وأبو رجاء والأعمش «الظالمون» بالرفع، وإذا أولنا العهد الدين أو الأمان أو أن لا طاعة لظالم فالظلم في الآية ظلم الكفر، لأن العاصي المؤمن ينال الدين والأمان من عذاب الله وتلزم طاعته إذا كان ذا أمر، وإذا أولنا العهد النبوءة أو الإمامة في الدين فالظلم ظلم المعاصي فما زاد). [المحرر الوجيز: 1/ 339-342]
تفسير قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: {وإذ جعلنا البيت مثابةً للنّاس وأمناً واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطّائفين والعاكفين والرّكّع السّجود (125) وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتّعه قليلاً ثمّ أضطرّه إلى عذاب النّار وبئس المصير (126)}
قوله وإذ عطف على إذ المتقدمة والبيت الكعبة، ومثابةً يحتمل أن تكون من ثاب إذا رجع لأن الناس يثوبون إليها أي ينصرفون، ويحتمل أن تكون من الثواب أي يثابون هناك، قال الأخفش: دخلت الهاء فيها للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع، لأنه قل ما يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطرا، فهي كنسابة وعلامة، وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدر، فهي مفعلة أصلها مثوبة نقلت حركة الواو إلى الثاء فانقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها، وقيل: هو على تأنيث البقعة، كما يقال: مقام ومقامة، وقرأ الأعمش «مثابات» على الجمع، وقال ورقة بن نوفل في الكعبة:
مثاب لأفناء القبائل كلّها ....... تخبّ إليها اليعملات الطلائح
{وأمناً} معناه أن الناس يغيرون ويقتتلون حول مكة وهي آمنة من ذلك، يلقى الرجل بها قاتل أبيه فلا يهيجه، لأن الله تعالى جعل لها في النفوس حرمة وجعلها أمنا للناس والطير والوحوش، وخصص الشرع من ذلك الخمس الفواسق، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «واتخذوا» بكسر الخاء على جهة الأمر، فقال أنس بن مالك وغيره: «معنى ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي {عسى ربّه إن طلّقكنّ} [التحريم: 5]، وقلت يا رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت {واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلًّى}».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «فهذا أمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم»، وقال المهدوي: «وقيل ذلك عطف على قوله: {اذكروا} فهذا أمر لبني إسرائيل»، وقال الربيع بن أنس: «ذلك أمر لإبراهيم ومتبعيه، فهي من الكلمات، كأنه قال: {إنّي جاعلك للنّاس إماماً} [البقرة: 124] {واتّخذوا}»، وذكر المهدوي رحمه الله: «أن ذلك عطف على الأمر الذي يتضمنه قوله: {جعلنا البيت مثابةً} لأن المعنى: توبوا»، وقرأ نافع وابن عامر «واتخذوا» بفتح الخاء على جهة الخبر عمن اتخذه من متبعي إبراهيم، وذلك معطوف على قوله: {وإذ جعلنا}، كأنه قال: وإذ اتخذوا، وقيل هو معطوف على جعلنا دون تقدير إذ، فهي جملة واحدة، وعلى تقدير إذ فهي جملتان.
واختلف في مقام إبراهيم، فقال ابن عباس وقتادة وغيرهما، وخرجه البخاري: «إنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت وغرقت قدماه فيه».
وقال الربيع بن أنس: «هو حجر ناولته إياه امرأته فاغتسل عليه وهو راكب، جاءته به من شق ثم من شق فغرقت رجلاه فيه حين اعتمد عليه»، وقال فريق من العلماء: المقام المسجد الحرام، وقال عطاء بن أبي رباح: «المقام عرفة والمزدلفة والجمار»، وقال ابن عباس: «مقامه مواقف الحج كلها»، وقال مجاهد: «مقامه الحرم كله».
و{مصلًّى} موضع صلاة، هذا على قول من قال: المقام الحجر، ومن قال بغيره قال مصلًّى مدعى، على أصل الصلاة.
وقوله تعالى: {وعهدنا} العهد في اللغة على أقسام، هذا منها الوصية بمعنى الأمر، وأن في موضع نصب على تقدير بأن وحذف الخافض، قال سيبويه: «إنها بمعنى أي مفسرة، فلا موضع لها من الإعراب»، و{طهّرا} قيل معناه: ابنياه وأسساه على طهارة ونية طهارة، فيجيء مثل قوله: {أسّس على التّقوى} [التوبة: 108] وقال مجاهد: «هو أمر بالتطهير من عبادة الأوثان»، وقيل: من الفرث والدم.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «وهذا ضعيف لا تعضده الأخبار»، وقيل: من الشرك، وأضاف الله البيت إلى نفسه تشريفا للبيت، وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى مالك، و{للطّائفين}: «ظاهره أهل الطواف»، وقاله عطاء وغيره، وقال ابن جبير: «معناه للغرباء الطارئين على مكة»، و{العاكفين} قال ابن جبير: «هم أهل البلد المقيمون»، وقال عطاء: «هم المجاورون بمكة»، وقال ابن عباس: «المصلون»، وقال غيره: المعتكفون.
والعكوف في اللغة اللزوم للشيء والإقامة عليه، كما قال الشاعر العجاج
... ... ... ... ....... عكف النبيط يلعبون الفنزجا
فمعناه لملازمي البيت إرادة وجه الله العظيم، و{الرّكّع السّجود} المصلون، وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى، وكل مقيم عند بيت الله إرادة ذات الله فلا يخلو من إحدى هذه الرتب الثلاث، إما أن يكون في صلاة أو في طواف فإن كان في شغل من دنياه فحال العكوف على مجاورة البيت لا يفارقه). [المحرر الوجيز: 1/ 343-346]
تفسير قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) }
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: {وإذ قال إبراهيم} الآية، دعا إبراهيم عليه السلام لذريته وغيرهم بمكة بالأمن ورغد العيش، و{اجعل} لفظه الأمر وهو في حق الله تعالى رغبة ودعاء، و{آمناً} معناه من الجبابرة والمسلطين والعدو المستأصل والمثلاث التي تحل بالبلاد.
وكانت مكة وما يليها حين ذلك قفرا لا ماء فيه ولا نبات، فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيره، ونبتت فيها أنواع الثمرات.
وروي أن الله تعالى لما دعاه إبراهيم أمر جبريل صلوات الله عليه فاقتلع فلسطين، وقيل قطعة من الأردن فطاف بها حول البيت سبعا وأنزلها بوجّ، فسميت الطائف بسبب ذلك الطواف.
واختلف في تحريم مكة متى كان؟ فقالت فرقة: جعلها الله حراما يوم خلق السموات والأرض، وقالت فرقة: حرمها إبراهيم.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «والأول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ثاني يوم الفتح، والثاني قاله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم»، ففي الصحيح عنه: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها حرام»، ولا تعارض بين الحديثين، لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه، وكون الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان، والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدثور، وكل مقال من هذين الإخبارين حسن في مقامه، عظم الحرمة ثاني يوم الفتح على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى، وذكر إبراهيم عند تحريمه المدينة مثالا لنفسه، ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه، ومن بدل من قوله أهله، وخص إبراهيم المؤمنين بدعائه.
وقوله تعالى: {ومن كفر} الآية قال أبي بن كعب وابن إسحاق وغيرهما: «هذا القول من الله عز وجل لإبراهيم»، وقرؤوا «فأمتّعه» بضم الهمزة وفتح الميم وشد التاء، «ثم اضطرّه» بقطع الألف وضم الراء، وكذلك قرأ السبعة حاشا ابن عامر، فإنه قرأ «فأمتعه» بضم الهمزة وسكون الميم وتخفيف التاء، «ثمّ أضطرّه» بقطع الألف، وقرأ يحيى بن وثاب «فأمتعه» كما قرأ ابن عامر «ثم اضطره» بكسر الهمزة على لغة قريش في قولهم لا إخال، وقرأ أبي بن كعب «فنمتعه» «ثم نضطره»، ومن شرط والجواب في فأمتّعه، وموضع من رفع على الابتداء والخبر، ويصح أن يكون موضعها نصبا على تقدير وأرزق من كفر، فلا تكون شرطا.
وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «هذا القول هو من إبراهيم صلى الله عليه وسلم»، وقرؤوا «فأمتعه» بفتح الهمزة وسكون الميم «ثم اضطره» بوصل الألف وفتح الراء، وقرئت بالكسر، ويجوز فيها الضم، وقرأ ابن محيصن «ثم اطّره» بإدغام الضاد في الطاء، وقرأ يزيد بن أبي حبيب «ثم اضطره» بضم الطاء.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: «فكأن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين».
و{قليلًا} معناه مدة العمر، لأن متاع الدنيا قليل، وهو نعت إما لمصدر كأنه قال: متاعا قليلا، وإما لزمان، كأنه قال: وقتا قليلا أو زمنا قليلا، والمصير مفعل كموضع من صار يصير، و «بيس» أصلها بئس، وقد تقدمت في «بئسما»، و{أمتعه} معناه أخوله الدنيا وأبقيه فيها بقاء قليلا، لأنه فان منقض، وأصل المتاع الزاد، ثم استعمل فيما يكون آخر أمر الإنسان أو عطائه أو أفعاله، قال الشاعر سليمان بن عبد الملك:
وقفت على قبر غريب بقفرة ....... متاع قليل من حبيب مفارق
ومنه تمتيع الزوجات، ويضطر الله الكافر إلى النار جزاء على كفره). [المحرر الوجيز: 1/ 346-349]